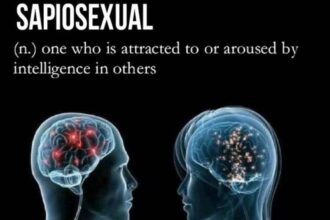بين الشّمولية والدّيمقراطية في ميدان الحق والقانون
بين الشّمولية والدّيمقراطية في ميدان الحق والقانون :
أ: يونس سليمان ناصيف
لقد ميّز الفكر السياسي الحديث بين النّظم الديمقراطية, من جهة, و الشّموليّة من جهة أخرى.
,حيث تتعارض النظم الشّمولية الديكتاتورية بكافة أشكالها مع الأنموذج التعدّدي للحكم الديمقراطي, ذاك الذي يتميّز بالفصل بين السلطة والمجتمع ,إذ أّن سلطة الدولة في الأنموذج الشمولي تتركز في الشّخص الواحد ,أو الجهاز الواحد , مايميّزها عن السلطة في الدولة الديمقراطية , التي تشكّل في آن معاً موضوعاً لتنافس انتخابي لأجل الوصول إليها, وتقوم على التقسيم الوظيفي بين أجهزة الحكم المختلفة..
- إن التمييز بين مختلف أشكال الحكم في الدولة لا يقوم على مسألة التنظيم المؤسساتي للسلطات وحدها. إذ يكمن الرّهان هنا بشكل أوسع في المفهوم (النظري , و الثقافي ,والعملي) لممارسة سلطة الدولة, كما يكمن في مستوى وشكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم .
- وعليه ,فإذا كان من الممكن التمييز في الدول بين النظم الديكتاتورية والنظم الديمقراطية, فإنَ هذه الثنائية غالباً ماتشير إلى طابع تبسيطي , بالقياس إلى الطابع الهجين لبعض النظم السياسية المعاصرة …
- إذاً , ثمّة أنماط من الدول :
1 ـ الدولة الديكتاتورية , التي غيّبت صورة الإنسان الحامي ,التي كانت تميز الديكتاتور الحاكم الاستثنائي , الذي يتولى السلطة قانونياً لفترة محدودة , لتصبح مكانها صورة الطّاغية ,الذي يترأس نظاماً تعسفياً مبعداً لأيّة عوامل من شأنها الحدّ من سلطته ,وانطلاقاً من سلسلة من المعايير , مثل : الأحاديّة في السلطة , وكيفيّة ودرجة التّعبئة العامّة , والتّركيز على أهميّة ومكانة الأيديولوجيا في عمل النظام ,فظهرت بذللك عبرالتاريخ الحديث فئتان من النظم , النظم السلطوية ,والنظم الشمولية..
2 ـ الدولة السّلطوية : التي تجعل أنظمة الحكم من “سلطة الدولة القيمة الأولى ” فتقوم هنا بإخضاع القانون لضرورات مصلحة الدولة العليا..
وبالمقارنة للأنموذجين السّابقين مع الأنموذج الديمقراطي, نرى أنّ النّظم السلطوية تتميز برفض تداول السلطة, ورفض التّنافس الانتخابي الحر , وإنكار أي دور للمواطنين “بمحاسبة أو بعزل” الحكام الذين يحتكرون السلطة , ويحرم المواطنون من الحقّ في أيّة معارضة سياسيّة , أو حريّة تعبير , مهما بلغت سلميّتها , وذلك بكافة الوسائل , بما فيها العنف , والإكراه..
3 ـ الدولة الشمولية : التي شهدها القرن العشرين , عبر التجارب التاريخية المختلفة المتمثلة في النظم النازية والفاشية والسوفييتية سابقاً ..
فرغم التّماثل بين تلك النظم ,إلا أنه ثمّة حدوداً لا يمكن تجاهلها. فهناك تعارض جوهريّ وكبير بين المشروع النازي ,أو الفاشي والمشروع السوفييتي في مضمار الأيديولوجية والمرامي.. ..
فمفهوم الدولة الشمولية في الأنموذج الفاشستي ,والذي ظهر في إيطاليا الفاشية , يقوم على مركزية الدولة والحزب الواحد , ويسعى إلى الوحدة عبر إلغاء الحدود بين الدولة والمجتمع المدني ,تلك الحدود التي قام على أساسها أنموذج الدولة الغربية ذات المرتكز في العقد الاجتماعي , وهنا تبتلع الدّولة المجتمع المدني , ويصبح الكل في الدولة , ولا أحد خارجها , ولا شيء ضد الدولة . وبذلك تتقدم الدولة بسلطتها , وتطغى على الحقوق والحريات الفرديّة. فتقوم بتركيز السلطات ,ومراقبة مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ,غير متسامحة مع أية قوة مقاومة ,سياسة كانت أم اجتماعية , أم ثقافية, وتحتكر السّلطة عبر الرعب بشقّيه : الأيديولوجي المرادف لاحتكار الحقيقة , والعملاني ” العنف “..
4 ـ الدولة الديمقراطية : والتي هي نتاج للثورتين الأمريكيّة والفرنسية ,نهاية القرن الثامن عشر والتي تقوم على مبدأ سيادة الشعب أو سيادة الأمة . ورغم انتشار هذا الأنموذج إلا أنّه لم يكف عن التطور باضطراد حتى عصرنا الحاضر.. .. - فدولة الحقوق والقانون التي هي عصارة الحضارة الأوروبيّة , ووليدة الثورات البرجوازية على الحكم المطلق , وأرست دعائمها الرأسمالية ,كأنموذج عالمي بديل لأنموذج الدولة الاستبدادية المؤيّدة من قبل السّلطة الدينية, تحتل فيها حقوق الإنسان والمواطنة مركزاً رئيساً في فلسفتها السياسية , إلى أن تم تأسيس المشروعية العلمانية الحديثة القائمة على الإعلان الشهير لحقوق الإنسان.. ..
- إذاً , تستمد الدّولة الدّيمقراطية مشروعيتها السياسية والتاريخية من تصويت مكوّنات المجتمع بطريقة مدنية, بحيث يصبح حق التصويت العام مصدراً للحقيقة ,ولمشروعية السلطة السياسية ـ باعتباره هذا الحق ركيزة النظام الديمقراطي ,وأحد مكتسبات الثورة الديمقراطية البرجوازية. فتقوم على النظام الدستوري العقدي بين دولة الحق والقانون , وحماية الحرية الفردية والملكية الخاصة للمواطن والمجتمع المدني, والدفاع عن حقوق المواطن الفردي ,التي لا تقبل التنازل عنها, وفكرة المساواة في الحقوق, وفكرة سيادة الشعب التي تشكل أساس دولة القانون التي غايتها الحق. وهنا يندرج مفهوم الأمة في ارتباطها العقائدي بالثورة الديمقراطية, إذ أن المسألة الديمقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الأمة, وتشكّل وجودها وكيانها السياسي ,الذي هو بالنّهاية الدولة القومية..
- ورغم أّن الثورة الديمقرطية البرجوازية في الغرب استطاعت تغيير وجه التاريخ والعالم والأرض نفسها, وإرساء دعائم الديمقراطية , والتي اقترنت بظهور طبقة برجوازية ثورية جديدة, وإن كانت قد حققت تحولاً ثورياً ,لكنها لم تحقق كامل حلمها التنويري الثوري, ولكن كان , وما زال حتى وقتنا الحالي أكبر تحول ثوري حدث في التاريخ.
.. غيضٌ من فيض من هموم ..
( دمتم بخير )