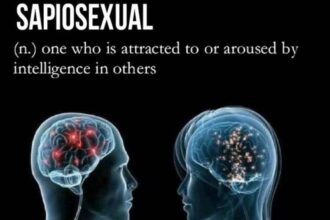صرخة تحت الصمت: وباء التحرش الجنسي بالأطفال في المجتمعات العربية والإسلامية – د. زبيدة القبلان | خاص لـ “أسامينا”
في الزوايا المنسية من منازل تبدو آمنة، وبين جدران يظنها الناس حامية، تتوارى قصص الطفولة المكسورة، وصرخات لم تجد من يسمعها. التحرش الجنسي بالأطفال ليس ظاهرة نادرة أو استثنائية، بل هو جرح مفتوح في صميم مجتمعاتنا، يتفاقم في صمت، ويواصل حصد أرواح بريئة تحت عباءة “العيب” و”الخوف من الفضيحة”.
وباء صامت… أرقام مقلقة
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلاً من بين كل أربع فتيات، وطفلاً من بين كل ستة إلى عشرة أولاد، يتعرضون لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي قبل سن الـ18. ورغم قسوة هذه الأرقام، فإن الواقع في العالم العربي والإسلامي قد يكون أكثر سوداوية، بسبب ندرة الإحصاءات الرسمية، وتكتم المجتمعات، وضعف آليات الإبلاغ. بعض الدراسات المحلية (في المغرب، الأردن، مصر، لبنان، وباكستان) كشفت نسباً صادمة، ما يؤكد أننا أمام جائحة صامتة لا تعترف بالحدود.
من يكمم أفواه الضحايا؟
يُحاصر الطفل المعتدى عليه بين جدران الخوف والعار، حيث تتكامل عدة عوامل ثقافية واجتماعية لتجعل من الحديث عن الجريمة عبئاً، ومن الضحية مجرماً:
ثقافة العيب والعار: حيث يتم تجريم الضحية بدلاً من معاقبة الجاني، خوفاً على “السمعة” أو “مستقبل الفتاة”.
سلطة الكبار: معظم المعتدين هم من داخل الدائرة المقربة، ما يضاعف شعور الطفل بالذنب، ويمنع العائلة من التبليغ.
الإنكار المجتمعي: كثيرون يفضلون تجاهل الواقع المؤلم على مواجهته.
ضعف الثقة في النظام القضائي: الخوف من الإجراءات المعقدة أو من إعادة تعريض الطفل للأذى أثناء التحقيق.
خلط الدين بالعادات: حيث تُستغل مفاهيم دينية خاطئة لتبرير الصمت، رغم أن الإسلام بريء من هذا التواطؤ.
ماذا يقول الإسلام حقاً؟
ينص الفقه الإسلامي صراحة على حرمة جسد الطفل وضرورة حمايته. يقول النبي ﷺ: “ليس منا من لم يرحم صغيرنا…” (رواه الترمذي). الإسلام يجرّم الاعتداء الجنسي بكل أشكاله، ويعدّه من الكبائر. كما يدعو إلى مناصرة المظلوم ورفع الظلم، لا إلى التستر عليه بحجة “الستر”. من هنا، فإن التواطؤ بالصمت لا يختلف عن الجريمة نفسها من حيث الأثر الروحي والاجتماعي.
تشريعات تقدّمت… ولكن!
شهدت بعض الدول العربية والإسلامية تقدماً تشريعياً ملموساً، مثل:
سنّ قوانين لحماية الطفل وتعريف واضح للتحرش والاعتداء الجنسي.
إنشاء وحدات متخصصة في الشرطة والنيابة والقضاء.
إطلاق مبادرات توعوية للأطفال والأسر.
لكن الفجوة لا تزال كبيرة:
تفاوت القوانين وضعف التنفيذ في بعض الدول.
نقص الكوادر المؤهلة للتعامل مع ضحايا من هذه الفئة الحساسة.
غياب الدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.
غياب الحماية الكافية أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة.
استراتيجية المواجهة: حماية الطفل مسؤولية الجميع
لوقف هذا النزيف الصامت، لا بد من تفعيل خطة شاملة تضم:
أولاً: تشريعات حقيقية وتطبيق صارم
تقوية النصوص القانونية.
تسريع الإجراءات القضائية.
فرض عقوبات رادعة ومعلنة.
ثانياً: توعية تبدأ من المنزل والمدرسة
تعليم الأطفال حدود أجسادهم، وتمييز اللمسات الآمنة والخطِرة.
تمكينهم من قول “لا” بثقة.
تدريب الأهل على كشف العلامات المبكرة والتعامل النفسي السليم مع الضحية.
ثالثاً: آليات دعم فعالة وسرّية
خطوط ساخنة للإبلاغ مضمونة السرية.
وحدات حماية تضم خبراء نفسيين واجتماعيين وأطباء شرعيين.
توفير علاج نفسي مجاني طويل الأمد للضحايا وأسرهم.
رابعاً: دور قيادي للمؤسسات الدينية
تصحيح المفاهيم الخاطئة.
رفع الحرج عن التبليغ.
التأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية دينية وأخلاقية لا تقل عن أي فريضة.
خامساً: تمكين المجتمع المدني
دعم الجمعيات والمنظمات التي تعمل في مجال حماية الطفل.
تسهيل إجراءات عملها وتوسيع نطاق تأثيرها إعلامياً ومجتمعياً.
لا صمت بعد اليوم
كل صرخة مكتومة من طفل معتدى عليه، هي صفعة لضميرنا الجمعي. كل مرة يُطلب من طفل أن يصمت لحماية “السمعة”، نخسر جزءاً من إنسانيتنا. لقد آن الأوان لكسر جدار الصمت، لا ببيانات متفرقة أو غضب مؤقت، بل بسياسات حازمة، ومجتمعات واعية، وأصوات لا تخشى العار بل تفضحه.
ليس من الشجاعة أن ندفن الرؤوس في الرمال، بل أن نُخرج الحقيقة إلى النور، مهما كانت قاسية. لأن الطفل المعتدى عليه اليوم، إن لم يُنصف، سيكون رجلاً أو امرأة مشروخة الروح غداً.
فلنبدأ من هنا…
أن نحمي أطفالنا، أن نمنحهم بيئة آمنة، أن نعلّمهم أن أجسادهم ليست متاحة لأحد، وأن صمتهم ليس خياراً… هذه هي بداية الطريق نحو مجتمعات سليمة، وإنسانية، تستحق أن تُسمى متحضّرة.