أهمية العلوم العقلية والإنسانية في تأسيس العلوم التجريبية
أسامينا
حرزالله محمد لخضر
أستاذ وباحث أكاديمي جزائري، متخصص في إدارة الموارد البشرية
هيمنت النزعة اللاهوتية على الفكر الأوروبي من القرن الـ5 الميلادي حتى القرن الـ15، حيث تسلط الاستبداد الكنسي على عقول الناس، وفرض أنظمة حياتية صارمة، فكانت الكنيسة تملي على الناس ما يعتقدونه، بل ما يجب أن يفكروا فيه، وعادت العلماءَ الذين يفكرون خارج إطار الكنيسة وقتلت بعضهم، وصادرت العقل والإرادة طوال أكثر من ألف سنة.
بعد أن تحررت أوروبا من سطوة الكنيسة، شهدت العلوم العقلية والفلسفية والرياضية انتعاشا كبيرا، ساهم في انتظام المعرفة في نسق بنيوي ممنهج ومتكامل
عبّر غوستاف لوبون عن تلك الحقبة بالقول: “تصفحوا تاريخ ما بين القرن الـ5 والقرن الـ15، تجدوا أن علم اللاهوت هو الذي يسيطر على الروح البشرية، ويوجهها، فتطبع جميع الآراء بطابع علم اللاهوت (Theology)، وتنظر إلى المسائل الفلسفية والسياسية والتاريخية من الوجهة اللاهوتية دائما، والروح اللاهوتية من بعض الوجوه هي الدم الذي جرى في عروق العلم الأوروبي حتى بيكون وديكارت”.
ويصور وُلْ ديورانت في مؤلفه “قصة الحضارة” الحالة الفظيعة التي تفشت في أوروبا آنذاك، والردة الفكرية التي انتابت الأوروبيين، واشتغالهم بالسحر والنحس والتطير، وإيمانهم بتحكم الجن والعفاريت في الكون؛ فيقول: يقول مونتيسكيو إن باريس كانت تعج بالسحرة وغيرهم من الدجالين الذين يكفلون للناس التوفيق في دنياهم، أو التمتع بشباب دائم، وقد اقتنع الكونت سان جرمان بأن في الإمكان إصلاح ماليات فرنسا التي فسدت بوسائل خفية لصنع الماس والذهب.
وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر والشعوذة مستعينا بالشيطان، أما أمير انهالت دساو العجوز، الذي كسب معارك كثيرة لبروسيا وكفر بالله، فكان إذا التقى بثلاث عجائز في طريقه إلى الصيد قفل إلى بيته، لأن “اليوم نحس”. وكان آلاف الناس يحملون التمائم أو الطلاسم اتقاء الشرور، واستُعملت مئات الوصفات السحرية علاجات طبية شعبية.
لكن، بعد أن تحررت أوروبا من سطوة الكنيسة، واستعادت الروح الفكرية النقدية، ونشطت حركة الترجمة، واستلهموا علوم المسلمين، خاصة في الأندلس وصقلية، وأُعيد الاعتبار للتفكير والمنهج العلمي، من خلال التخلص من الأفكار الميتة والقاتلة، وبناء وترتيب المعرفة وتحديد مصادرها، آنذاك شهدت العلوم العقلية والفلسفية والرياضية انتعاشا كبيرا، ساهم في انتظام المعرفة في نسق بنيوي ممنهج ومتكامل.
و”الأمر نفسه يمكن استصحابه مع حالة العرب في الجاهلية وبعد الإسلام، حيث حدثت نقلة نوعية في الفكر، صحبتها ثورة على التقاليد الجامدة، فانبعاث للحضارة واحتضان للعلوم.”
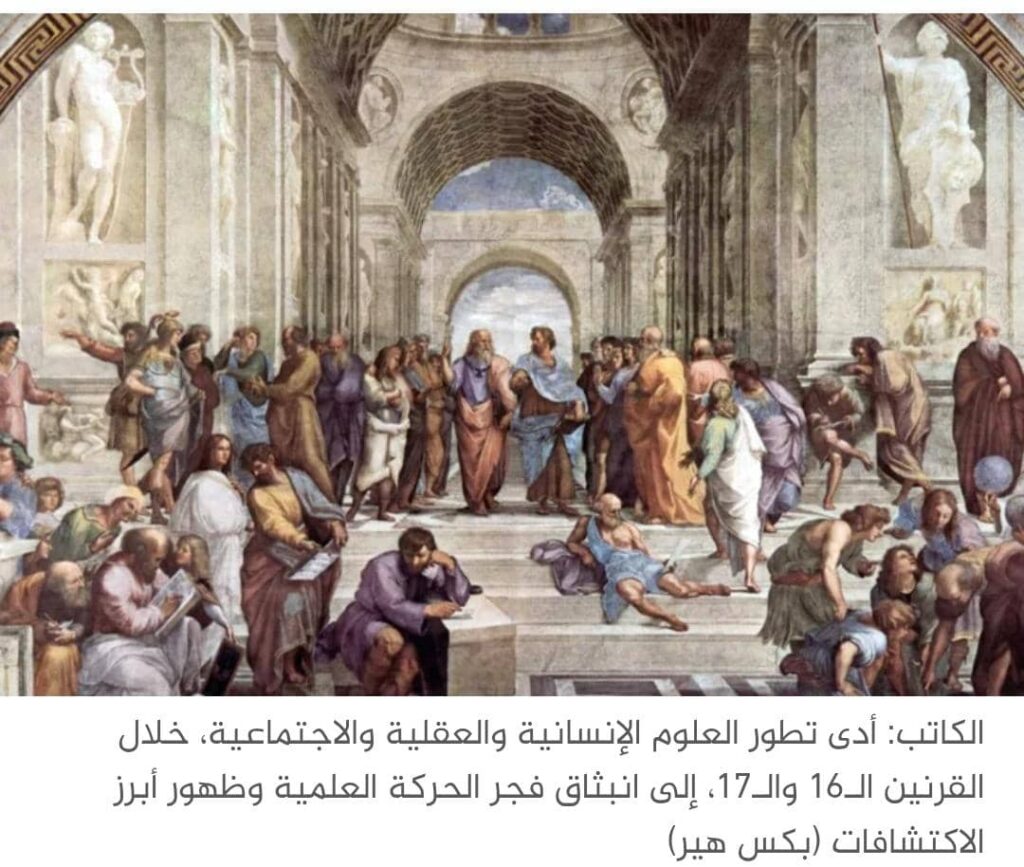
أدى تطور العلوم الإنسانية والعقلية والاجتماعية، خلال القرنين الـ16 والـ17، إلى انبثاق فجر الحركة العلمية وظهور أبرز الاكتشافات، ابتداء بالتجارب التي أجراها غاليليو في الفيزياء، ثم اكتشاف اللوغاريتم على يد العالم نابير (1614)، وبحوث هارفي
جاء في كتاب “المنهج العلمي عند علماء العرب: محاولة في الفهم” ما نصه: “مثلت هذه المرحلة لأوروبا طور الإبداع والازدهار، وهي تلك المرحلة التي تمثلت في اختراع المنهج اختراعا؛ في عصر فرانسيس بيكون “Francis Bacon”، وافتتاح عصر التشريح، والنزعة العلمية التي حدثت في الميكانيكا والفلك، والثورة على الأفكار التقليدية في الفلسفة، وتقدم العقل في مكوناته الأساسية، وغيرها من الأفكار والآراء التي سادت الفترة الممتدة من القرن الـ17، وحتى نهاية القرن الـ19”.
لقد أدى تطور العلوم الإنسانية والعقلية والاجتماعية، خلال القرنين الـ16 والـ17، إلى انبثاق فجر الحركة العلمية وظهور أبرز الاكتشافات، ابتداء بالتجارب التي أجراها غاليليو في الفيزياء، ثم اكتشاف اللوغاريتم “Logarithms” على يد العالم نابير (1614)، وبحوث هارفي “Harvey” عن الدورة الدموية (وإن كان ابن النفيس قد سبقه إلى ذلك)، وكذلك استخدام الرموز العشرية على يد بريجز (1617)، ثم نشر نظريات فرانسيس بيكون في مؤلفه “الأداة الجديدة للعلوم” (1620)، ليُفَصّل فيه المنهج التجريبي وخطواته، ثم يظهر بويل “Boyel” كأب للكيمياء الحديثة، ثم آثار نيوتن “Newton” في الرياضيات عن قوانين الجاذبية (1679)، وقد ظهر مع هؤلاء آخرون غيرهم.
كل ما سبق يجعلنا نؤكد أن المنهج التجريبي لم يتطور بشكل كامل إلا بعد حدوث تحول جذري للفكر، وتصحيح للمفاهيم الخاطئة، ولا شك أن هذا يؤكد لنا الدور الأساسي للعلوم الإنسانية والفلسفية، الذي يتجلى في جانبين مهمين:
عصمة الفكر من الانحراف والجمود والتسليم المطلق دون مناقشة أو محاججة.
تطوير نظام التفكير عبر تنمية الحس النقدي البنائي واتساق الفكر مع قواعد المنطق.
إن المنهج التجريبي هو أداة قوية، لكن الأفكار الفلسفية والإنسانية التي أدت إلى ظهوره هي بلا شك أكثر أهمية، فالعلوم الإنسانية تزودنا بـ”لماذا نفكر؟” و”كيف نفكر؟”، مما يجعل المنهج العلمي ممكنا
ويمكن على سبيل المناقشة أن نستدل ببعض الكليات والمنطلقات، التي تبدو على أنها من مبادئ المنهج التجريبي، غير أن منابتها تكونت ضمن أحضان الفلسفة والعلوم الإنسانية، والتي وضعت أسس التفكير السليم والإطار الصحيح الذي تُناقش فيه العلوم التجريبية والتقنية، ومن خلالها استمدت العلوم التجريبية قواعدها ومناهجها، ومن ذلك:
أسبقية التساؤل: أيتساءل الإنسان أولا ثم يُجري تجاربه أم العكس؟ وهل لهذا التساؤل أهمية على صحة التجربة؟ من المؤكد أن السؤال يسبق التجربة.. وامتلاك القدرة على التشكيك وطرح الأسئلة المناسبة، ونقد الأفكار القديمة لتحرير العقل من أغلال التبعية، ودفعه للبحث عن أسئلة أكثر واقعية وموضوعية، ذلك منهج فلسفي بامتياز. وبناء عليه، فالمنهج التجريبي في جوهره هو وسيلة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة.
لكن، من أين تأتي هذه الأسئلة في الأصل؟ إنها تنبع من الفضول الإنساني، والتفكير النقدي، والرغبة في تحدي المعتقدات الراسخة؛ فقبل أن يتمكن غاليليو من إجراء تجاربه على الأجسام المتساقطة، كان عليه أولا أن يتساءل عن مدى صحة الاعتقاد الأرسطي القديم بأن الأجسام الأثقل تسقط أسرع، والأمر نفسه حصل مع نيوتن عند اكتشافه قانون الجاذبية. وهذا التساؤل النقدي هو جوهر الفلسفة والفكر الإنساني.
رفض الجمود الفكري: لقرون طويلة، كان الفكر الأوروبي مقيدًا بـ”الدوغما” (الاعتقاد الأعمى)، وقبول الأفكار من السلطات القديمة (مثل أرسطو) أو النصوص الدينية، وكانت فترة النهضة هي الفترة التي بدأ فيها المفكرون في رفض هذا الإطار الفكري الجامد. لقد طوروا منظورًا جديدًا يقدّر التفكير المستقل، والأدلة التجريبية، والاستدلال المنطقي فوق التقاليد، وهذا التحول الفكري الذي هو سمة مميزة للعلوم
الإنسانية، كان شرطا ضروريا لكي يصبح المنهج التجريبي وسيلة شرعية لاكتساب المعرفة.
الإطار المفاهيمي: المنهج التجريبي لا يعمل في فراغ، فهو يتطلب إطارا مفاهيميا يتضمن أفكارا مثل السببية، وموثوقية الملاحظة، والافتراض، وقابلية الدحض (أي إن الفرضية يجب أن تكون قابلة لإثبات خطئها). هذه كلها مفاهيم فلسفية كان لا بد من مناقشتها وتطويرها وقبولها قبل أن يتم تطبيق المنهج التجريبي بفاعلية.
إن المنهج التجريبي هو أداة قوية، لكن الأفكار الفلسفية والإنسانية التي أدت إلى ظهوره هي بلا شك أكثر أهمية، فالعلوم الإنسانية تزودنا بـ”لماذا نفكر؟” و”كيف نفكر؟”، مما يجعل المنهج العلمي ممكنا، إنها تعلمنا التساؤل، والبحث عن الحقيقة، وفهم مكانتنا في هذا العالم. وعلى هذا الأساس نبني الأدوات لاستقصائه وتطويره.






